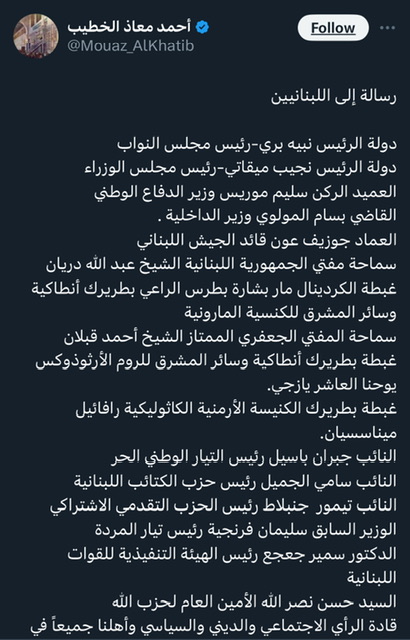من حال إلى حال / بقلم فؤاد مطر
مجلة الشراع 9 تشرين الثاني 2020
لم يحدث أن إنشغل البال العربي بمصير إنتخابات رئاسية تجري في بعض دول تتداخل مصالحها مع مصائر سياسات وكيانات في العالم الثالث ومنها العالم العربي في شكل خاص، كإنشغال البال بالإنتخابات الرئاسية الأميركية يخوضها بعزيمة غير مألوفة جو بايدن (الديمقراطي) ودونالد ترامب(الجمهوري) الذي يتطلع إلى ولاية ثانية كتلك التي نالها الجمهوري الآخر جورج بوش الإبن الذي جاء فوزه يثأر لإخفاق مُني به والده الذي خطف منه الديمقراطي بيل كلينتون التمتع كرئيس بما إعتباره أمجاد حرب حررت الكويت من غازيها الصدَّامي وأدخلت عراق ذلك الغازي في أتون إحترابات أهلية من كل نوع ما زالت غير مكتومة الأنفاس إلى أن يحقق سعي الرئيس مصطفى الكاظمي الآمال بالإمساك بكافة مفاتيح الاستقرار وحُسْن العلاقة مع الجيران ودول العالم عموماً نازعاً الأقفال الألغام واحداً تلو الآخر.. وإلى أن يهدي الله "شعوب" بلاد الرافدين إلى نعمة تستحق شعوب لبنان المستقوى عليه الحصول عليها، ناهيكم ﺑ "شعوب سوريا" و "شعوب ليبيا" و "شعوب اليمن".
على مدى سنوات الولاية الرئاسية الأُولى كانت للرئيس ترمب فتوحات وإجتهادات تجاه قضايا عالقة. وكانت له إختراقات جريئة لجدران علاقات غير محسومة سواء مع كوريا الشمالية أو حتى مع الصين، فضلاً عن تسجيل مواقف متعالية تقبَّلها بعض رفاق الدرب الأطالسة بنسبة من المرارة، لكن هذه كلها هي الجزء البسيط من الشأن السياسي الذي يشكل عنصر ثقة مفرطة في أن يتم التجديد لرئاسته بل وربما التأسيس لحقبة طويلة من بقاء الولايات المتحدة برئاسات جمهوريين. وهذا الشعور عكَسَه بنفسه حيث أنه خاض السباق الرئاسي ومن قبْل الإنطلاق بأسابيع ليس بأسلوب الواثق بنفسه من أن الفوز يمكن أن يحالفه، وإنما الإصرار على أنه يجب أن يفوز وأن من واجب الشعب الأميركي الناخب أن يختاره رئيساً لدورة ثانية.. وإلاَّ يترك أميركا بدافع الإحتجاج أو لدواع يحتسب مفاعيلها. كما أعطى من خلال عبارات في مناظرات أو من خلال تويتراته الشهيرة إنطباعاً خلاصته أن الولاية الرئاسية الثانية ساعية إليه وسيتقبلها برحابة. وهو في ذلك كان على درجة من التعالي وعلى ثقة في الوقت نفسه أنه لن يكتسب فقط أصوات الجمهوريين وإنما أصوات قطاعات عريضة من (الديمقراطيين).
هذا الفيض من الثقة بالنفس وإلى حد التعالي لم يتكون نتيجة إنجازات داخلية حققها وإنما بفعل الورقة العربية التكوين التي توفرت له يوم تعزز شأنه في ضوء تلك القمة العربية-الإسلامية غير المسبوقة التي إستضافتْها الرياض يوميْ 20 و21 مايو/أيار 2017 وكانت مشاركته فيها أول زياراته الخارجية، بل إن مردود تلك الزيارة شجعه على المزيد من الزيارات الصعبة أسيوياً كانت أو أوروبية، ولم تنعقد تلك القمة من أجْل رد جمائل مواقف إتخذها وإنما لتدعيم شأنه وتقبُّل الأمتين برحابة لوجه غير سياسي ومن مجتمع رجال الأعمال المجلين رئيساً للدولة العظمى ذات الكلمة ثلاثة أرباع الفصل في المصائر الكونية حروباً أو سلاماً أو مشاريع تسوية. كما كانت بمثابة رسالة لم تتحقق لرئيس أميركي من قبل وخصوصاً أنه في سنته الرئاسية الأُولى، أراد الملك سلمان بن عبدالعزيز منها القول للرئيس ترمب وبإسم قادة الأربع والخمسين دولة عربية وإسلامية: ها أنت في حضرة مَن يمثل شرعية الأمتيْن العربية والإسلامية، وتلك هي الأحوال الشائكة والعالقة التي في إستطاعة الولايات المتحدة معالجتها من خلال سياسة تميز بين الحق والباطل وبين المعتدي والمعتدى عليه وبين المتطلعين إلى السلام وأولئك الذين يمتهنون العدوان على الآخرين.
طوال ثلاث سنوات تزايدت الأحوال الشائكة أشواكاً وبقيت كفة الباطل أعلى، كذلك كفة المعتدين. وفي الوقت الذي تزايد الإلتفاف الشعبي في الولايات المتحدة حول ترمب نتيجة عوائد تركيز منه على العلاقة مع الإقتدار العربي الذي له الدور النوعي في تفادي نكسات نوعية في المجال الصناعي، الإستراتيجي منه بنوع خاص، فإن المأمول من الإدارة الترمبية الإقدام عليه لم يأت وإنما الإكتفاء بجولات لوزير الخارجية بومبيو لا تثمر أفعالاً، وإجراءات عقابية مالية لا تحسم مواقف، وإبتداع صيغة للسلام في المنطقة لم تكتمل فصولاً كون الطرف المعطل للسلام بقي على تعطيله. تلك هي "الإنجازات".. إلاَّ إذا كانت تصفية قاسم سليماني بإستهداف وأسلوب يختلف عن إستهداف أسامة بن لادن في زمن أوباما، هما ما يعتبره الرئيسان ترمب بعد أوباما "إنجازات" العصر.
من هنا فإن إنشغال البال العربي بالإنتخابات الرئاسية الأميركية ليس لأن جو بايدن أفضل من دونالد ترمب بالنسبة إلى القضايا العربية والإسلامية، كما تبين في ضوء السنوات الأربع الماضية أن ترمب ليس أفضل من جو بايدن، وإنما لأن التميز هو بين من لم يثمر العطاء له وبين من ليس من المصلحة القومية والوطنية الرهان بالمثل عليه. وما دامت باتت الولايات المتحدة منقسمة وربما تزداد إنقساماً فإن التعامل المطمئن الذي لا ينتج صدمات هو أن يأخذ مساره الواقعي في ضوء ما أوجزه الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس باراك أوباما خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض يوم الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول 2015 ومحادثاته في اليوم التالي مع الملك سلمان ووليّ العهد الأمير محمد وكذلك مشاركته في قمة عقدها قادة مجلس التعاون الخليجي وتشاور قبل مجيئه إلى الرياض من أبو ظبي مع وليّ عهد دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في شأنها كما في شؤون كثيرة مستقبلية. وأما الإيجاز من جانب الملك فكان قوله "إن علاقة الرياض بواشنطن مفيدة للعالم". وعلى اللبيب أن يفهم الكلام يأتي بصيغة ما قل ودل من كبير أمتيه، سلمان بن عبدالعزيز.
وبالعودة إلى مسألة إنشغال البال نشير إلى أن المتابعة وعلى مستوى العالم العربي للأيام الانتخابية الأميركية كانت غير مسبوقة، وكانت في بعض مراحلها مثل متابعة مبارة كرة قدم بين فريقيْن لكل منهما بطله المتفوق ماسي أو محمد صلاح لجهة تحقيق أهداف في شباك الفريق الآخر. بل حتى وصل الأمر إلى مَن يراهن كما من يتحزب للرئيس المرشح ترمب أو للنجم (الديمقراطي) جو بايدن الحالم وغير النعسان بمنصب الرئيس وهو الذي ذاق سابقاً طعم نيابة الرئيس وعايش أي حلاوات لمذاق ذلك المنصب.
هذا على صعيد الناس العاديين. أما بالنسبة إلى الذين في رحاب السلطة والحكومات فهؤلاء كانوا يتابعون المشهد الإنتخابي المثير بدرجة من التنبه وفي الوقت نفسه يفترضون نتائج تستوجب إعادة قراءة متأنية في ضوء تقلبات في المواقف وحالات من عدم رد الجمائل حدثت. وبطبيعة الحال لن تكون الأحوال العربية-الأميركية بدءاً من 2021 كما كانت عليه بدءاً من العام 2017 في ظل رئيس إحترنا في أمر إغراقه إسرائيل نتنياهو بحقوق شعوب وأوطان وعندما حانت لحظة الرد على الجمائل فإن ما أصاب ترمب من أكثرية يهود أميركا ومن بنيامين المتخم بهدايا صديقه حتى نهاية الولاية الرئاسية الأُولى هو ما أصاب سنمار. وأما القصر فللساكن الجديد الذي نتمنى أن يكون بأفعاله نقيض الرئيس ترمب. وإلا فسيبقى إنشغال البال العربي على حاله. فما بين غمضة عين وإلتفاتتها.. يغيِّر الله من حال إلى حال.